بانتظار مبادرة شجاعة لمواجهة الأزمة
حتى إذا بدا الأفق مسدودا والاحتقان فى مصر على أشده والانقسام حتى النخاع، فإن الأزمة ليست بلا حل.
(1)
لئن قيل إن فهم المشكلة يمثل نصف الطريق إلى حلها، فإن ذلك ينطبق على ما نحن بصدده أيضا. وفى محاولة الفهم ينبغى أن نضع فى الاعتبار ما يلى:
• إن ما تشهده مصر الآن أقرب إلى الهزات الأرضية التى تظل تتوالى بعد حدوث الزلزال، الأمر الذى لا ينبغى له أن يصدمنا، حيث أكرر ما سبق أن قلته من أن ذلك من طبائع فترات الانتقال التى تعقب الثورات وما تستصحبه من تحولات كبرى تستهدف بناء نظام جديد فوق أنقاض ومخلفات النظام السابق.
• إن الثورة تسلمت مصر بعدما تم تدميرها على مختلف الأصعدة. نلمس ذلك فى كلام وزير النقل حين قال إن 85٪ من قطارات السكة الحديد انتهى عمرها الافتراضى. وحديث وزير الصحة عن انتهاء العمر الافتراضى لأربعة آلاف مستشفى. وتصريح وزير الشباب بأن 42٪ من المواطنين محرومون من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والصرف الصحى والمياه النظيفة. وهو ما أكده وزير المرافق الذى نشر على لسانه قوله إن 50٪ من قرى مصر محرومة من الصرف الصحى، الأمر الذى يعنى أن صحة 40 مليون مصرى فى خطر. وقبل أيام سمعت من وزير التربية والتعليم أنه يحاول جاهدا معالجة آثار الانهيار إلى حل فى قطاع التعليم بسبب تراكمات وإهمال السنوات السابقة، حتى باتت الوزارة بحاجة إلى 50 مليار جنيه لكى تؤدى وظيفتها بشكل مرض يطمأن إليه. وهذه مجرد أمثلة فقط ترسم ملامح التركة الثقيلة التى يتعين على النظام الجديد أن يتحمل عبئها.
• إن الخراب تجاوز قطاعات الخدمات والإنتاج وإنما طال أكثر مؤسسات الدولة، وأصاب فى مقتل الحياة السياسية فيها. وهذه الأخيرة تهمنا لأنها وثيقة الصلة بالأزمة الراهنة للثورة المصرية. ذلك أن التدمير الذى أحدثه النظام السابق لم يكتفِ بتقزيم بعض الأحزاب السياسية وإصابتها بالإعاقة، وتحويل البعض الآخر إلى أبواق للسلطة وأجنحة للحزب الحاكم فحسب، وإنما أدى إلى تشويه علاقات القوى السياسية، وحرق البدائل المستقبلية للنظام. وكانت نتيجة ذلك التشويه والإخصاء ــ إذا جاز التعبير ــ إن القوى السياسية التى ظهرت بعد الثورة بدأت الرحلة من الصفر. فلم تبلور مشروعا، ولم تألف العمل مع بعضها البعض، حيث لم تكن هناك حياة أو ممارسات ديمقراطية تسمح بذلك. فلا تبادلت الثقة فيما بينها، بل وأساءت الظن ببعضها البعض.
• هذه الخلفية تفسر لنا لماذا كانت الثورة بلا مشروع وبلا قيادة أو زعامة، لأن الممارسة والسياسة بأشكالها وأوعيتها هى المختبر الذى يتم من خلاله اكتشاف القيادات وإنضاج خبراتها. وهو ما يدعونا إلى القول بإن الذين تصدروا واجهات السياسة بعد الثورة لم يكونوا مبرأين من التشوهات التى أصابت رؤى وعلاقات القوى السياسية فى ظل النظام السابق، كما أنهم كانوا عديمى الخبرة السياسية، حيث ظلوا دائما ــ وفى أحسن فروضهم ــ على هامش السياسة وليس فى قلبها. وصاروا كمن دخل إلى الحلبة بغير تأهيل أو تدريب. وكانت الجماعات الإسلامية ضمن هؤلاء إلا أن وضعها كان أكثر تعقيدا كما سنرى توا.
(2)
سأتحدث عن الوضع فى مصر، ليس فقط لأن الصورة التى أعنيها أكثر وضوحا فيه، ولكن أيضا لأن مصر هى الدولة العربية الأكبر التى يمكن أن يؤثر مصير الثورة فيها على مستقبل الربيع العربى كله. ذلك أن الجماعات الإسلامية فى مصر، وعلى رأسها الإخوان المسلمون، أتيح لها لأول مرة منذ أكثر من ستين عاما أن نشارك فى الحياة السياسية بصورة شرعية، بعدما ظلت محظورة طوال تلك السنوات.
لقد شاءت المقادير أن تنتقل تلك الجماعات من موضع المطارد من جانب السلطة إلى موقع الشريك فى السلطة، بل المتربع على رأسها. هذه النقلة فوجئت بها الجماعات الإسلامية ولم تتحسب لها. لذلك فإنها أصبحت مواجهة بتحد جديد يتمثل فى كيفية تحويل الشعارات والتعاليم إلى سياسات. وهو ما لم تكن مضطرة إليه طوال سنوات الإقصاء بسبب الانسداد الديمقراطى الذى أخرجها من المعادلة. وكانت النتيجة أنها عانت الارتباك، ولم تنجح فى التعامل مع الوضع المستجد واستيعاب المشهد الذى فرض عليها الانتقال من إدارة الجماعة ومحيط الأنصار إلى إدارة الوطن بفضائه الذى يموج بأطياف عدة تضم مخالفين ومتوجسين وخصوما.
التجربة التركية نجحت فى التعامل مع ذلك التحدى بسبب الهامش الديمقراطى الذى سمح للحركة الإسلامية بالمشاركة فى الانتخابات منذ عام 1970، من خلال حزب النظام الوطنى الذى أسسه حينذاك الأستاذ نجم الدين أربكان، صحيح أن الحزب تعرض للملاحقة والحل عدة مرات، لكنه ظل حاضرا بفضل الهامش الديمقراطى الذى سمح لقياداته بالعودة إلى المشاركة تحت مسميات جديدة. المهم فى التجربة أن المشاركة التى لم تتوقف سلحت كوادر الحزب بخبرات جيدة فى العمل العام، من خلال الاشتراك فى البلديات والبرلمان والحكومة. لكن الأهم من ذلك أنها سمحت لتلك الكوادر بتطوير أفكارهم وإنضاجها، الأمر الذى دفع بعضا منهم إلى الخروج من عباءة حزب أربكان (الذى كان قد حمل اسم الرفاه) وتأسيس حزب جديد فى عام 2011 بقيادة كل من رجب طيب أردوغان وعبدالله جول، ولأن هذه المجموعة كانت قد تمرست، ونجحت فى وضع سياسات خدمت الناس وتفاعلت مع مختلف فئات المجتمع، فإن الحزب فاز بأغلبية الأصوات فى انتخابات عام 2002، ولا يزال يواصل نجاحاته إلى الآن مدعوما بأصوات الأغلبية.
هذا المعنى أشرت إليه فى محاضرة عن الوضع فى مصر ألقيتها مؤخرا فى مدينة «استنبول»، وقلت فيها إن الحركة الإسلامية فى مصر لا تزال أسيرة ثقافة المرحلة الأربكانية (نسبة إلى نجم الدين أربكان)، ولم تنقل بعد إلى نضج المرحلة الأردوغانية. التى مثلها رجب طيب أردوغان.
(3)
هذه الخلفية توفر لنا عدة مفاتيح لفهم خلفيات النخبة التى تتصدر المشهد السياسى فى مصر. وبالتالى تضع أيدينا على أهم جوانب الأزمة وجذورها. ذلك أننا بإزاء نخبة فاقدة الثقة فى بعضها البعض، وتقوم علاقاتها على التصيُّد. وقد عبر عن ذلك الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء السابق، الذى نشرت له جريدة «الشروق» مقالا فى الثالث من شهر أبريل الماضى (عام 2012) تحت عنوان دال هو: التربص وعدم الثقة. ذلك أن تلك المجموعات المختلفة لم يتح لها أن تعرف أو تعمل مع بعضها البعض بسبب الغياب الطويل للديمقراطية. بالتالى فإنها لم تتسلح بالخبرة السياسية التى تمكنها من أن تدير خلافاتها على النحو الذى لا يضر بمصالح الوطن، لذلك لا يستغرب منها أن تستسلم للانقسام وتقع فى فخ الاستقطاب بسرعة. وإذا كانت القيادة السياسية ممثلة فى رئاسة الجمهورية تنتمى إلى نموذج للمرجعية الإسلامية التى لم تطور مشروعها بحيث تحوله من شعارات وتعاليم إلى سياسات ورؤية وطنية واضحة المعالم، فلا يفاجئنا أن تغيب عنها الرؤية التى تطلق مبادرات تشحذ الهمم وتحقق الإجماع الوطنى. وللإنصاف فإن غياب الرؤية والمشروع ليس مقصورا على إدارة الرئيس محمد مرسى وحدها، ولكنها سمة للأحزاب الجديدة والقوى المعارضة أيضا، التى ظل مشروعها المعلن على الملأ على الأقل محصورا فى العمل على هزيمة الرئيس مرسى والإخوان والتنديد بالخطوات التى اتخذها طوال الأشهر السبعة التى قضاها فى السلطة، دون أن تجيب عن السؤال: ما الذى ينبغى عمله فى اليوم التالى لإعلان هزيمته وهدم ما بناه؟
إذا جاز لى أن ألخص ما أتصوره جذورا للأزمة فلعلى أقول إنها تتمثل فى غياب الثقة بين الجماعات السياسية، وضبابية الرؤية لدى القيادة، وغياب الحلم المشترك الذى يشد الجميع ويلهمهم.
(4)
ما العمل إذن؟
قدر الدكتور محمد مرسى أن يتحمل القسط الأكبر من مسئولية مواجهة الأزمة باعتباره رئيس الجمهورية والطرف الأهم فى المعادلة. لست ألغى الطرف الآخر أيا كان تقييمنا له. لكنه يظل فى المقام الثانى من المسئولية. وللأسف فإن دعوة الرئيس إلى الحوار الوطنى لم تؤخذ على محمل الجد. لذلك فإن الحديث مجددا عن ذلك الحوار سوف يستقبل بفتور وربما بأعراض من الأطراف الأخرى.
مع ذلك فالحوار لا مفر منه ولا بديل عنه فى نهاية المطاف، إلا أن نجاحه مرهون بضمانات الجدية التى تتوافر له، وتلك ينبغى أن تكون جزءا من حزمة إجراءات إعادة الثقة المفقودة بين الطرفين. التى على الرئيس أن يقدمها من جانبه بها مهتديا فى ذلك بأمرين أساسيين هما: تحقيق وحدة الجماعة الوطنية، والالتزام بأهداف الثورة.
أعيد التذكير هنا بالقصة القرآنية التى ذكرت فى سورة «طه»، وقبل فيها النبى موسى موقف أخيه هارون حين سكت على تحول قومه من عبادة الله إلى عبادة العجل من دونه. ولم يدفعه إلى ذلك السكوت إلا خشيته من أن ينفرط عقد الجماعة وينشق صفهم إذا ما نهاهم عن فعلتهم التى كانت بمثابة ارتداد إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويحضرنى أيضا موقف قيادة حركة النهضة فى تونس، التى قبلت باستبعاد الإشارة إلى مرجعية الشريعة فى الدستور الجديد. والاكتفاء بالنص على أن تونس بلد يدين بالإسلام، وقول رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشى إنهم أرادوا بذلك أن يتجنبوا الشقاق بين القوى السياسية فى المجتمع. وقد تراجع حزب العدالة والتنمية فى تركيا عن إلغاء القيود التى فرضت على ارتداء الحجاب، بل وسحب مشروع قانون قدم إلى البرلمان يجرم الزنا، لا لشىء إلا لتجنب الانقسام فى المجتمع.
إن هناك أكثر من سبب أسهم فى إحداث الانقسام وتعميقه فى مصر (فى نصوص الدستور وقانون الانتخابات مثلا)، ولذلك فإنه سيكون من الحكمة والشجاعة أيضا أن يعلن الرئيس عن التزامه بالاستجابة لتحفظات المعارضة بخصوصها، حتى إذا لم يكن مقتنعا بأهمية أو جدية تلك الأسباب، لكى يزيل أسباب الانقسام ويستعيد الثقة المفقودة. وستكون شجاعة منه إذا بادر بالإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مع الانتخابات النيابية التى يفترض أن تتم بعد ثلاثة أشهر. وليته أيضا يدعو إلى فتح ملفات السياسة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتعليم والعشوائيات وغيرها من هموم المصريين، من خلال مجالس تضم أبرز الخبرات والأطياف المصرية لتقدم لنا رؤية واضحة للمستقبل الذى تطلعت إليه الثورة. وبالمناسبة فإن الدكتور عماد شاهين أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية له أفكار محددة ومقترحات جيدة بخصوص المبادرات الشجاعة المرجوة من الرئيس مرسى وإدارته، ولست أشك فى أن الخبراء من أمثاله لديهم مقترحات أخرى جديرة بالنظر للخروج من الأزمة. ويظل من المهم أن تتوافر الإرادة ويستوعب الخيال حلم الوطن ويظل قابضا عليه ومتشبثا به.







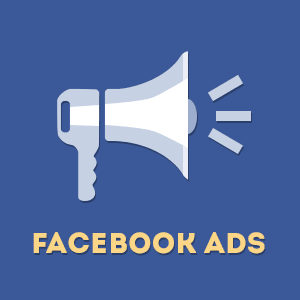







التعليقات