وهم المسافة الواحدة
إذا ألقينا نظرة سريعة إلى الوراء، قبل أن تخطف أبصارنا نتائج الانتخابات الرئاسية، سنكتشف أن من بين ما تم ابتذاله خلال الأسابيع الماضية مصطلح «المسافة الواحدة». ذلك أنه ما من مسئول فى موقع حساس إلا وتحدث عن التزامه بالمسافة الواحدة بين المرشحين، واعتبر أن التصريح بذلك يشكل غطاء كافيا لتحيزاته على أرض الواقع. فالمجلس العسكرى أعلن مرارا أنه يقف على مسافة واحدة، فى حين أن ممارسته التى تجلت أمامنا أخيرا شككتنا فى دقة تلك المقولة. واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية قالها بمنتهى الثقة والقطع، فى الوقت الذى كان رجاله يحرسون تحركات أحد المرشحين. والمفتى الدكتور على جمعة لم يقصر فى إثبات وقوفه على مسافة واحدة من المرشحين، لكنه حذر من التلاعب بالدين فى الانتخابات. والأنبا باخوميوس قائم مقام بطريرك الكنيسة الأرثوذوكسية أكد حكاية الالتزام بالمسافة الواحدة، فى حين نشرت الصحف مرارا، آخرها أمس، أن الكنيسة حشدت أنصارها لصالح الفريق أحمد شفيق. والدكتور كمال الجنزورى انضم بدوره إلى جانب فريق المسافة الواحدة، فى حين أن جهاز الإدارة له انحيازه المعروف... إلخ. الإعلام «القومى» وأغلب قنوات التليفزيون وبرامجه لم تستخدم المصطلح صراحة ولكنها لم تكف عن الحديث عن الموضوعية والنزاهة، وكانت حقا تستضيف الجميع مع ترجيح واضح لكفة مرشح دون آخر، الأمر الذى ذكرنى بالحوارات التى تجرى فى بعض المحافل، وتدعى إليها كل الأطراف. ولكن يمثل الطرف الليبرالى والعلمانى عشرة أشخاص، فى حين يدعى واحد فقط أو اثنان من الطرف الإسلامى. ويقال للملأ إن الجميع موجودون. ثم لا يعطى الواحد أو الاثنين فرصة للحديث. وتكون النتيجة أن ينقض العشرة عليها من كل صوب ويعلن انتصار الأولين «واكتساحهم» للآخرين. بمضى الوقت فقد مصطلح المسافة الواحدة رنينه وتم تفريغه من مضمونه. وتحولت اللغة فى هذه الحالة إلى أداة ستر وتضليل وليس إبانة وتوصيل. الأمر الذى أدى إلى طمس معالم خريطة المواقف والتحيزات الثقافية والسياسية، وجعلنا نستحضر فى العديد من المواقف المثل الشائع الذى يقول: أسمع كلامك أصدقك، أتابع أمورك أستعجب. إزاء ذلك فلا مفر من التعامل مع المصطلحات التى تستخدم فى الاشتباك أو التجاذب السياسى بحذر. إذ ليس يكفى أن يعلن الرمز أو المسئول موقفا إيجابيا حتى نصدقه ونطمئن إليه، وإنما يتعين أن نؤجل حفاوتنا به حتى نتثبت من أن الممارسات على أرض الواقع تؤيد ذلك الموقف وتجسده. بكلام آخر فإننا لا ينبغى أن نصدر حكما لمجرد استماعنا إلى إجابة السؤال ماذا، وإنما نتعين أن نتوصل أيضا إلى الإجابة الصحيحة على السؤال «كيف». الحقيقة التى يتعين الاعتراف بها ــ خصوصا بعد خبرة الأشهر الأخيرة ــ أن حكاية المسافة الواحدة فى الفضاء المصرى كانت ــ ومازالت ــ أكذوبة كبرى.. إذ لم يلتزم بها أغلب الذين تفرض عليهم مسئولياتهم الوظيفية والمهنية أن يحافظوا على تلك المسافة. ليس فقط من قبيل المسئولية الأخلاقية والأمانة المهنية، ولكن أيضا حفاظا على صدقيتهم وتعزيزا للثقة فيهم. إذا وسعنا الدائرة قليلا وحاولنا أن نسبر أغوار الظاهرة، فسنجد أن المسألة أعمق من كونها مجرد تلاعب بالألفاظ أو إهدارا للمعانى. ذلك أن استعمال اللغة فى التضليل والتمويه من تجليات افتقاد المجتمع إلى الشفافية. إن شئت فقل إنه من علامات النفاق والرياء، التى يعتبرها عبدالرحمن الكواكبى فى كتابه «طبائع الاستبداد». حيث لا يملك أحد جرأة مواجهة الآخر بوضوح وشجاعة. فالسلطة المستبدة تنافق المجتمع وتستر قبح ممارساتها بخطاب تتجمل به وتدغدغ مشاعر الناس، ورجالها ورموز الدولة المستبدة يسيرون على ذات الدرب، وتصبح الحقيقة هى الضحية فى نهاية المطاف. فى الحالة المصرية لا مفر من الاعتراف بأن مؤسسات الدولة وجهاز الإدارة وأبواق الإعلام لها تحيزاتها الثابتة التى لم تتغير منذ أكثر من ستين عاما استمر خلالها الصراع بين السلطة والإسلاميين، وأن ما نحن بصدده الآن ليس سوى استمرار ذلك الصراع، ربما بوسائل أخرى. وهو وضع لن يتغير إلا إذا نجحنا فى إقامة المجتمع الديمقراطى الذى ننشده. الذى تترسخ فيه قيمة احترام الآخر، ويتسلح الجميع بالشفافية التى تطهر الفضاء السياسى والثقافى من الكذب والنفاق، وتلك لعمرى رحلة طويلة، مازلنا نتعثر فى خطواتها الأولى.







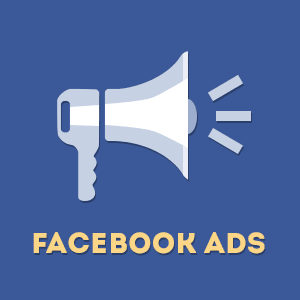







التعليقات