الخط الأحمر
أحذر من الدببة الذين نصَّبوا من أنفسهم حماة للجيش ودعونا إلى تقديسه، فأساءوا إليه من حيث لا يحتسبون، إذ زعموا تارة أنه «فوق الجميع» وحدثونا تارة أخرى عن أنه يمثل «خطا أحمر» لا يجوز الاقتراب منه ناهيك عن تجاوزه، وقرأنا أن منهم من طالب «بقطع لسان» كل من داس للجيش على طرف أو ذكره بغير المديح والإجلال. وقال قائلهم إن أى ذكر من ذلك القبيل يعد إهانة له وإهدارا لثوابت الأمة.
لم أجد فرقا بين هؤلاء وبين دراويش الكمالية فى ثلاثينيات القرن الماضى. حين كان غلاتهم يعتبرون المساس بالذات الإلهية من قبيل ممارسة حرية الرأى، فى حين اعتبروا توجيه أى نقد «للغازى» مصطفى كمال أتاتورك مساسا بالثوابت الوطنية ينبغى أن يقابل بكل حزم، كانوا معذورين آنذاك، فذلك المجتمع المحارب بطبعه وجد فى الغازى مصطفى كمال الرجل الذى حقق له أمله وجسد كبرياءه، حين قاد فى عام 1920 حركة المقاومة الوطنية ضد جيوش الاحتلال التى توجت بتحرير الأناضول واسطنبول ومن ثم أنقذت الدولة من الانهيار.
ولأنه قاد حرب التحرير فقد أصبحت رئاسة الأركان العامة هى مركز القرار السياسى فى الداخل والخارج، حتى إنه فى دستور عام 1921 أصبح مصطفى كمال هو القائد العسكرى العام، ورئيس مجلس النواب ورئيس هيئة الوكلاء التنفيذيين (مجلس الوزراء)، وجرى تحصينه ضد المساءلة أمام مجلس النواب، وبذلك جمع الرجل بين السلطات العسكرية والسياسية والتشريعية وأصبح معلوما للكافة أن الجيش يحمى الدستور والدستور يحمى الجيش، على نحو كاد يوحى بأنه ليس فى البلد سوى الجيش.
بعض صفحات هذا التاريخ أصبحت الآن موضوعا للتندر بين الأجيال الجديدة للمثقفين الأتراك. صحيح أن الجيش لايزال له احترامه هناك، ولكن الممارسة الديمقراطية نزعت عنه هالة القداسة التى أضفاها عليه البعض. وأصبح الآن يعامل بحسبانه مؤسسة وطنية شأنها شأن بقية مؤسسات الدولة، وليست متعالية فوق ما عداها. وهو ما تجلى ليس فقط فى تراجع الدور السياسى لرئاسة الأركان، لكنه تجلى أيضا فى إخضاع ضباط القوات المسلحة وقادتها للقوانين الحقوقية المقررة فى البلاد. وهو ما أدى إلى محاكمة نحو 300 من العسكريين بتهم التآمر ضد الحكومة، وقبل أسبوعين ــ فى 10/10 ــ أيدت محكمة الاستئناف أحكام السجن لمدة 20 عاما بحق ثلاثة من أولئك القادة بعد إدانتهم فى جريمة التآمر التى ارتكبوها قبل 10 سنوات.
من الأمور المثيرة للدهشة حقا، الدالة على الخلل الفادح فى ترتيب الأولويات، أن الجدل فى وسائل الإعلام حول الغيرة المفتعلة على كرامة الجيش بما استصحبه من مزايدات وترهيب، أخذ حظا من الاهتمام تجاوز بكثير أى قضية حيوية فى مصر. فقد سكت الجميع على إعداد الدستور الجديد فى السر، ولم ينشغل أحد بقضية العدالة الانتقالية المعلقة، ولم يفهم أحد لماذا يصدر قانون جديد للإرهاب، فى حين أن ما هو قائم بالفعل يؤدى الغرض وزيادة. ولايزال ملف انتهاكات حقوق الإنسان والمحاكمات العسكرية للمدنيين مؤجلا. كما أن ما يجرى فى سيناء لايزال بعيدا عن اهتمام الرأى العام، فى حين أن أهالى سيناء يضجون بالشكوى من المداهمات والاعتقالات والاجتياحات التى تتعرض لها قراهم، ولا يجدون أذنا تصغى إليهم أو يدا تضمد جراحهم.
إننى أخشى أن نكرر خطيئة مبارك، حين جمد كل شىء فى البلد طوال السنوات العشر الأخيرة من حكمه، لكى ينصرف إلى ترتيب مستقبل ابنه وتوليه السلطة من بعده. وهو ما يفعله المزايدون والمهللون والمهووسون هذه الأيام، حين يؤجلون كل شىء يخيروننا بين أن نشارك فى حملة مديح الجيش وتسويق الفريق السيسى أو أن نصمت. وجزاء الذين يفتحون أفواههم بما يخالف هذا السيناريو أن يتعرضوا للتشويه والتخويف والتخوين.
مثلما استفزتنى مقولة أن الجيش ينبغى أن يكون فوق الجميع، فقد أثار استيائى أيضا ذلك الادعاء بأن الجيش خط أحمر، ذلك أننى أزعم أن الخط الأحمر الحقيقى الذى ينبغى ألا نختلف عليه هو كرامة المواطن التى باتت تشكل علامة استفهام كبرى فى الوقت الراهن. أما أن يكون الجيش بمثابة خط أحمر يتفرد به بالمقارنة ببقية المؤسسات الوطنية فذلك تمييز لا مسوغ له، وتزيُّد لا محل له. لأن احترام مؤسسات الدولة ينبغى أن يظل من مسلمات ومقتضيات إقامة الدولة المدنية التى توقف الحوار بشأنها حتى نسيها كثيرون فى غمرة الصراع حول الأنصبة والحظوظ السياسية.
أليس غريبا بعد مضى نحو ثلاث سنوات على الثورة أن نبذل جهدا لإقناع الرأى العام بأن المجتمع لم يسقط دولة الشرطة فى عهد مبارك لكى يقيم بدلا منها دولة الجيش؟







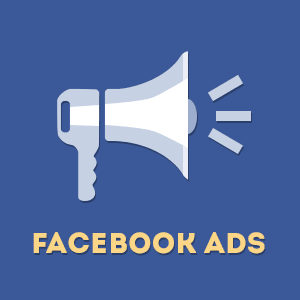







التعليقات